اليأس، الأمل وإزدهار الأدب..عن حقبة الستينيات
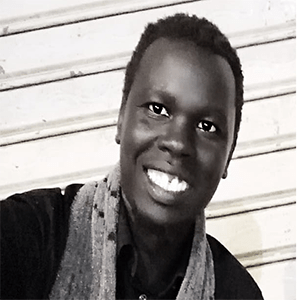
رداً على رسالتك المؤرخة بالرابع والعشرين، من الشهر الثامن للسنة العشرين بعد الألفين، من ميلاد سيدنا المسيح، والمعنونة بـ(الخوف، الأمل والأفكار الكبيرة.. عن رواية الستينيات). أكتب إليك..
العزيز بوي جون
قلت في مستهل رسالتك إن: “الإشتغال روائيًا على حقبة الستينيات فعل جميل، ولكن شديد الإرهاق”.
أشاطرك الرأي، رغم أنني كنت أفضل أن تقول : فعل شديد الإرهاق، ولكن جميل.
حقبة الستينيات يا صديقي شهدت تناقضات وأحداثًا غريبة، إلتقت بسببها دموع الفرح بدموع الحزن كإلتقاء النيلين. كانت حقبة مليئة باليأس، والأمل، الركود، والازدهار. حقبة لمعان الإشتراكية، وسطوع الليبرالية! مما جعلني أطلق عليها عقد (الحلو مُر).
لماذا؟
بعد إنتهاء الضائقة العظيمة أي الحرب العالمية الثانية،والتي جعلت الناس يعتقدون بأن تلك السنوات الست، هي التي قال عنها السيد المسيح : “يكون في تلك الأيام ضيق، لم يكن مثله منذ إبتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن، ولن يكون”!.
كان العالم فاقدًا للأمل، غارقًا في اليأس ، حتى ساد اعتقاد أقرب إلى اليقين، بأن لا شيء سينتشلهم من تحت ركام المدن المدمرة! أو على الأقل يمسح عن مخيلاتهم صور الفظاعات التي ارتُكبت خلال الحرب.
استمرت هذه الحالة طوال النصف الثاني من الأربعينيات، وجل حقبة الخمسينيات، ولكن مع نهايتها، وفي بداية الستينيات، أشرق نور الأمل وسط ظلمة اليأس. ومع الازدهار الإقتصادي بدأ الناس في الحلم بعالم سعيد، لا يُسمع فيه قعقعة أصوات البنادق، أو صرخات الأطفال المفزوعين، أو عويل الأرامل الحزانى.
ولكن ماذا حدث؟
على الرغم من صمت دوي مدافع الـ(إلدورا)، وأزيز طائرات الـ(بي – 25)، والنمو الإقتصادي الكبير، الذي كان يبشر بحياة هانئة وراحة بال، إلا أن الحقبة بدأت وانتهت بأحداث عاصفة ومتناقضة حتى في التسميات! فخطة ماو تسي تونغ الإقتصادية المسمى بـ(قفزة عظيمة للأمام)، تحولت إلى قفزة كارثية للخلف ، ففي غضون ثلاث سنوات، من ١٩٥٨م إلى ١٩٦١م، مات أكثر من ٣٠ مليون شخص بالمجاعة! وفي المقابل تحولت خطوة “نيل أرمسترنغ” الصغيرة إلى قفزة كبيرة للبشرية، عندما حط على سطح القمر كأول إنسان يفعل ذلك .
بين هذين الحدثين شهدت الستينيات جملة من الأحداث الجسام ،على سبيل المثال: غزو خليج الخنازير، أزمة الصواريخ الكوبية، بدء تشييد جدار برلين، اغتيال جون كينيدي، مالكوم أكس، و مارتن لوثر كينغ، الذي سقط قتيلًا وبقي حلمه حيًا. الحلم الذي تحقق بصورة لم يتخيلها “كينغ” نفسه، حينما أصبح باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في العام ٢٠٠٨م .دون أن ننسى أنها كانت حقبة لأسخن فترات الحرب الباردة، وصراع الأيدولوجيات ، وتوازن الرعب الذي حدث بين القوتين العظيمين، الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي.
ولكن رغم كل هذه الأحداث المزلزلة، كانت حقبة الستينيات من أنضر الفترات بالنسبة للأدب، والموسيقى في العالم أجمع، فعلي سبيل المثال في أمريكا اللاتينية ظهرت أعمال روائية لمجموعة من الشباب على رأسهم “ماركيز” ، “ماريو فارغاس يوسا” ، “خوليو كورتاثر” ، “كارلوس فوينتس” .. وآخرين، وقد أحدثوا فيما بعد، نقلة نوعية في عالم الإبداع. ويكفي أن تقرأ أعمالًا مثل” مائة عام من العزلة”،” لعبة الحجلة”، “موت أرتيمو كروث” لتدرك سبب نيلهم مثل هذه الشهرة.
حتى “بورخيس” الذي يكبرهم سنًا وكتابة، نال نصيبه من الستينيات، حيث بدأت شهرته الدولية في مطلعها، و اكتملت في النصف الأخير منها ، حينما تعاون مع المترجم الأمريكي” توماس دا جيوفاني”.
في الموسيقى، شهدت هذه الحقبة، سطوة موسيقى “الروك”، وهوس” البيتلز” الذي اجتاح العالم، ولمعان ملك الروك “ألفيس بريسلي”، بعبقريته الفذة وهو يمزج بين موسيقى “الكونتري” و”الروك اند رول” .
في أفريقيا كانت حقبة الستينيات أشد غليانًا من بقية العالم، من الناحية السياسية، ففيها شهدت أفريقيا، غرب إفريقيا بالتحديد، الحرب البرتغالية الاستعمارية ، حرب التحرير التي خاضتها مجموعة من حركات الإستقلال على رأسها الأحزاب الشيوعية في كل من غينيا، أنغولا، موزمبيق.. الخ.
وفي شمال إفريقيا كانت هزيمة التحالف بقيادة مصر سنة ١٩٦٧م في حرب الست أيام، عندما تفوق سلاح الجو الاسرائيلي. هذه “النكسة” لم تؤثر سلبيًا في جيل الستينيات من الأدباء أمثال، “صنع الله ابراهيم” ، و”الغيطاني” .. الخ.، بل فتحت لهم آفاقًا جديدة، ظهرت في كتاباتهم، مثل روايته (٦٧) التي عالج فيها روائيًا حياة المجتمع في تلك الفترة.
وفي شرق إفريقيا كان المستعمر الانجليزي في آخر أيامه يعيث فسادًا في كينيا ويقوم بالتنكيل بثوار حركة الماو ماو. وفي الجنب منها، كانت “لؤلؤة إفريقيا” تغسل أحزانها في بحيرة “فيكتوريا”، إيذانًا بخروج أحفاد “فكتوريا” .
في القرن الأفريقي كانت رائحة البارود، تعبق في كل الأرجاء بدلًا عن رائحة القهوة ! نتيجة لحرب الإخوة الأعداء بين إريتريا واثيوبيا .
ومع ذلك حملت حقبة الستينيات أخبارًا مبهجة لإفريقيا، ففي الفترة ما بين ١٩٦٠م حتى ١٩٦٨م نالت إثنتان وثلاثون دولة إستقلالها من المستعمر الأوربي بموجب قرار “إنهاء إستعمار إفريقيا. وهي السنوات التي رفعت فيها، رايات الأماني الكبيرة، المشاريع العملاقة ، وعصا (البان آفريكان)، على يد آباء الاستقلال “نكروما”،” نيريري”،” بن بيلا” ” كينياتا” ،” لوممبا”،” كابرال”، و ” أحمد سيكو توريه “. وكانت ثمرة نضالهم ميلاد منظمة الوحدة الأفريقية.
* ملاحظتان عن الأدب الأفريقي، أو الأدب في أفريقيا :
الأولى تتمثل في الظلم الكبير الذي يقع علي إفريقيا، عندما يوصف الأدب فيها بـ(حديث العهد). فالأشعار، الملاحم، القصص الشفاهية الإفريقية، تعتبر أدبًا بإمتياز، وهي غنية جدًا. إلا أنها ظلت حبيسة الصدور لفترة طويلة لغياب التدوين، رغم جهد الألماني “أوجست سيدل”. ولكن هذا لا يمنعنا القول: بأن الأدب في أفريقيا ضارب في القدم.
الثانية تتمثل في النظر إلى إفريقيا – خصوصا من الرجل الأبيض – كغابات، تتشاركها الحيوانات مع أناس غير متحضرين، وبالتالي وجب فعل كل شيء نيابة عنهم! وهذا بالضبط ما فعله “كونراد” في روايته الممعنة في العنصرية “قلب الظُلمة”!.
عاشت أفريقيا، مثلها مثل باقي أجزاء العالم أبهى مراحل الخلق والفعل الأدبي في الستينيات، وهي فترة لمعان نجم أديبنا الكبير “لوليونق” ورفاقه “وانجالا”، “نغونغي” ، و”أوكوت” حيث أنجزوا فيها عندما كانت كلية الآداب بجامعة نيروبي، مصنعًا لإنتاج الأدب، ما أصبح فيما بعد مرجعًا للأدب الشرق أفريقى. النجومية، لم تقف عليهم فقط بل شملت على سبيل المثال “وولي شوينكا” ، حينما أبهر العالم برائعته “المفسرون” في منتصف الستينيات، وكريستوفر أوكيجبو، جون بيير كلارك، أوكيلو اوكيلي، دينيس بروتس.. وآخرون.
في السودان كان مرجل الأحداث السياسية يغلي ؛ سياسات الديكتاتور عبود القمعية، الإنيانيا وظهور لاقو البطل المنقذ حينذاك، وتصاعد حدة الحرب، مجزرة بابنوسة ، مجزرة المثقفين (واو) ، ثورة أكتوبر، مؤتمر المائدة المستديرة، إنقسام حزب سانو، اغتيال وليم دينق نيال.. الخ. كلها أحداث شهدتها الساحة السياسية السودانية.
وفي المقابل كانت الساحة الثقافية والأدبية تمور بحراك ثقافي كبير، وإزدهار عظيم. فمن خلف الضباب أخرج الأديب الأكبر الطيب صالح من مخيلته الفذة “موسم الهجرة إلى الشمال” ومن غابات كينيا، بدأ لوليونق قول “كلمته الأخيرة”، وحتى “أسطورة الحرية وأشعار أخرى” لشاعرنا العظيم سر اني كلويلجانق تخلقت في رحم الستينيات!.
النهضة الثقافية شملت كل الفنون، ففي الغناء، لمع نجم محمد وردي، عثمان حسين، إبراهيم عوض، صلاح بن البادية، محمد الأمين، صلاح مصطفى. وفي الموسيقي ظهرت أول فرقة جاز، على يد “الطيب رابح”،” فؤاد علامة” و “ناصر ساكس”، اللذين شكلوا بالإضافة إلى “كمال كيلا”، “شرحبيل احمد” رواد الجاز في شمال السودان، وفي الجنوب كان “إميل عدلان” وصحبه يؤسسون للموسيقى الجنوبية الحديثة كما تفضلت.
هذا الزاد – أي زاد الستينيات- الغنائي فاض لدرجة أن ثورتي “أبريل”، و”ديسمبر” استطعمتا من الـ(إكتوبريات)!.
في هذه الفترة أيضا ظهرت أجسام ساهمت في النهضة الأدبية، مثل تجمع الكتاب والفنانيين التقدميين (أبادماك)، كتجمع للمثقفين من أدباء، مسرحيين، وتشكيليين، أمثال عبد الله علي ابراهيم، طلحة الشفيع، عبد الله جلاب، صلاح يوسف، عبد الرحيم أبو ذكرى.. الخ. طلائع الهدد، النخيل، القندول.. الخ. وتيار الغابة والصحراء بقيادة محمد المكي ابراهيم وصحبه، وشهدت هذه الحقبة إنشاء معهد الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية الذي مثل نقطة تحول كبيرة في الفن السوداني.
يكمن جمال الكتابة عن تلك الحقبة – بالإضافة- إلى كونها خصبة، وغنية بالأحداث، في أنها أيضا تمثل مرحلة إنتقال من اليأس إلى الأمل، من دمار الحرب العالمية الثانية، إلى إزدهار السلام العالمي، لذلك لا غرابة في أن يتمنى الكثيرون الرجوع إلى تلك الحقبة للعيش فيها.
العودة التي حققها الكُتاب بالحروف، كما فعلت أنت في جنة “الخفافيش” عندما عدت بنا بصحبة “أركانجلو مرجان” إلى حادثة مجزرة المثقفين في واو. وكذلك عندما عادت “إديتشي” إلى حرب بيافرا في رائعتها “نصف شمس صفراء”.
صعوبة الكتابة عن هذه الحقبة، – اتفاقًا مع ما ذهبت إليه- تدور وجودا وعدما مع صعوبة الإجابة عن أسئلة السرد، ماذا تحكي؟ ، كيف تحكي؟ وسأضيف سؤال :لماذا تحكي؟. وأعتقد بأننا قد أجبنا عليها مسبقًا من خلال هذه (الونسة)!. لطالما اتفقنا على أن كل القصص صالحة للمعالجة الروائية. وهذا سيحيلنا مباشرة إلى أهمية إجادة بناء فضاء للرواية.
رغم أهمية الفضاء إلا أنه “هناك قصور وإهمال في الدراسات النقدية حوله، مقارنة مع عناصر الحكي الأخرى” (السرد، الشخوص، الزمكان..)، وهذا ما أقره “باختين”، “ميتران”، و”فيسجربر” الذي يقول: “إذا كنا عالجنا بإسهاب وظيفة الديكور فإننا نجهل في الوقت الراهن كيفية تشكل الوسط الفضائي حيث يدور السرد”!. لذلك كثيرا ما يقع الخلط بينه وبين المكان، الذي يمثل جزءًا من الفضاء الذي يتميز بإتساع دلالي، وشمول .وهذا الشمول هو ما أكده “يوري لوتمان” عندما عرف الفضاء على أنه: “مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظواهر والحالات، والوظائف والصور والدلالات المتغيرة.. الخ. “
إذا فالفضاء الروائي، يتكون من مجموع الشخوص، الأحداث، الأمكنة، أو بعبارة أخرى هو الحيز الذي تدور فيه كل عناصر الرواية. وهذا ما يفسر قول” أمبرتو ايكو” بأن بناء فضاء معماري للرواية في بعض الأحيان يأخذ منه نصف فترة كتابة العمل!.
قول “ايكو” هذا يقودنا لسؤال مهم وهو : بماذا يتم بناء فضاء الرواية، أي ما هي الأدوات المطلوبة لذلك ؟
اللغة بالطبع ؟
هذه الإجابة تقودنا بدورها إلى سؤال آخر وهو: أي لغة ؟
مع اتفاقنا التام على أن اللغة تعتبر من أهم، بل أهم أدوات الكاتب، إلا أنه مطالب بنوع معين من اللغة : اللغة الأدبية. الواضحة، الجميلة، البليغة.
ولإعطاء النص حقه الكامل يتطلب من الكاتب المعرفة الواسعة باللغة، وأن يتوفر لديه إحتياطي من مفردات القاموس الأدبي، ومن ثم تنمية قدرته على اختيار أوضح الكلمات ، و أبلغها جمالًا، حتى يستطيع بناء فضاء للرواية قوامه أمكنة ضاجة بالحركة، وأزمنة قابلة للتصديق، وشخوص حية تقنع القارئ.
إقتناع القارئ يقودنا إلى سؤالك، حول القارئ المفترض. وهل من الضروري أن يكون في ذهن الكاتب وهو يكتب قارئ مفترض يتوجه إليه ؟
بالطبع ضروري، وضروري جدًا. وهذا أمر لا مفر منه، فالقارئ هو الذي يخلق الكتاب في آخر المطاف كما يقول “بول أوستر”.
إذن من هو القارئ المفترض؟.
هو أنت في المقام الأول : “الأنا الاخر”، “القرين” ، أو “الظل”.. الخ لا يهم، المهم أن تضعه في الاعتبار أثناء وبعد الكتابة .
قد يتساءل المرء عن مدى ثقافة القارئ المفترض، أو هل يحق للكاتب إختيار قارئ مفترض معين؟ فلنقل مثقفًا .
نعم يحق للكاتب ذلك، بل يجب عليه.
انظر ماذا يقول “امبرتو ايكو” عن أهمية القارئ المفترض المثقف: ” كل ما كان هذا القارئ مثقفًا وذكيًا كلما كان الكاتب متمكنا في موضوعه وصياغته”.
وحتى القارئ الحقيقي يجدر به ان يكون مثقفًا :
“نحن نكتب لأناس قرأوا عشرات بل مئات النصوص “
ولو تأملنا قول “إيتالو كالفينو” أعلاه لاستخلصنا بأنه قصد الثقافة بقوله: (…. قرأوا عشرات بل مئات الكتب).
إذن فإن القلق على مدى تلقي، أو فهم القارئ للنص فهما جيدًا ليس له مبرر طالما كان هذا المتلقي مثقفًا .
تقول متسائلًا:
“كيف يستطيع المرء الكتابة في زحمة الحياة هذي؟ فدائما هنالك شيء ناقص.. عندما تجد مكانا للكتابة بـ(مزاج) لا تجد الوقت الكافي. وعندما تجد الوقت لا تجد المكان المناسب”!
في الحقيقة لا أعرف كيف يستطيع المرء الكتابة في زحمة الحياة هذي، خصوصا وأنا من اللذين لا يحبون الضجيج، أو قل ” الزحمة”. ولكن هذه الحالة أشبه بقصة خيالية من تأليفي حدثت في إحدى قرى” الدينكا” ببحر الغزال. القصة تحكي عن شخص متزوج حديثًا، ذهب مع زوجته لزيارة أهلها، وكانت الزيارة – حسب اتفاقهما- لمدة يوم واحد فقط، ولكن لسوء حظه وجد والد زوجته متأهبًا لزيارة بعض أقربائه في قرية أخرى، فأصر عليهما بأن يمكثوا لبضعة ايام لحين عودته! . فقبل “العريس” الأمر على مضض.
في الأيام الست التي مكثها هناك، كانت الرغبة في ممارسة الحب تنهشه!. ولكنه واجه مشكلة حالت دون الحصول على ما أراد. فبسبب قلة الغرف “القطاطي” بالمنزل كان ينام في غرفة مشتركة مع ثلاث شبان، وزوجته تنام في غرفة أخرى مع والدتها وإحدى خالاتها!
استمر في تلك الحالة لمدة تسعة ايام، في النهار يجد زوجته، ولكنه ليس الزمن المناسب لممارسة الحب. وعند حلول الظلام وهو الزمن المناسب لذلك، لا يجد زوجته!.
ختاما..
الإبداع يا صديقي يحتاج إلى جو خاص، ومحفزات، كالهدوء مثلًا الذي يجعل الخيال يعمل بأقصى طاقته، لذلك أتفق معك، ومع “أورهان باموق” في أن الكتابة يجب أن تمارس في مكان منفصل عن غرفة النوم، ومكان المعيشة، خصوصا في مجتمعنا الذي يعتبر الكتابة ترفًا، أو شيئًا لا أهمية له. لذلك قد تسمع كما قلت – أنت- “قد تسمع أفراد الأسرة يقولون ما تزعجوا الدكتور.. نزلوا أصواتكم هو مشغول.. لكن من المستحيل ان تسمع من يقول ما تزعجوا فلان هو قعد يكتب”!.
قد تسمع أيضا في الشارع العام شخصًا يصف آخرًا بقوله : “ده كاتب ساي”، على وزن ده كلام جرائد ساي!.
مع أطيب الأمنيات
الحاج يوسف – 2 أيلول 2020م
