بني عامر وحباب والدولة السودانية : في ذكرى الثورة الأريترية
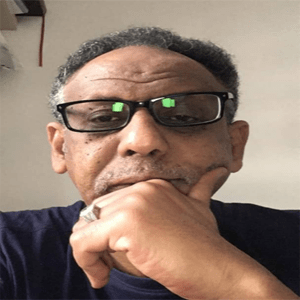
القضايا الواضحة لا تحتاج إلى عنوان بالطول الذي اخترته لهذا المقال الذي ينطلق من فرضية أن الهياج الذي ينتظم الإعلام وسؤال من أين أتى هؤلاء الناس عند ذكر بن عامر وحباب ؛ هذا الهياج ناتج من الأزمة التاريخية للدولة السودانية التي لم تكلف ذاتها في لحظة من عمرها أن تفصح عن مشروع وطني واضح مع الجماعات التي سورها التاريخ الحديث بمأزق الحدود الموروثة من الاستعمار لتكون خارطة جغرافية سياسية تسمى دولة السودان ، التي لا أعلم حقًا لماذا تسمى جمهورية؟ أي ماهي الجمهورية . تلك الشخصية الإعتبارية التي تسمى دولة عليها واجبات إبتداءً تجاه من هُم لاحقًا يكونون الجماعة الوطنية. وأكبر خلل في تفكير الدولة أو كل المجال العام الذي يتحرك في الفعل السياسي والثقافي المناط به عملية البناء الوطني أنها تتعالى على فكرة أساسية تعتبر من أكبر حقائق الوجود الإنساني في فضاء السودان، تلك الفكرة أن أكثر من ثمانين في المائة على وجه التقريب لا يجيدون اللغة العربية وأن الدولة السودانية ومجالها المتسع لسانها عربي ولها إنسانٌ أول يجود بتراثه لصناعة المشروع الوطني حتى بلغ درجةً من التماهي لايرى معها سواه . لذلك يسأل عن سودانية من لا يرى صورته فيه . دعونا نبسط الأمر ونعود للوراء زمنيًا، منذ عشية الاستقلال إلى مطلع الثمانينيات كم ياترى عدد الذين لايفهمون الخطاب العام لأسباب عملية وهو حاجز اللغة ؟؟وكم عدد الذين إلتحقوا بالتعليم منهم مقابل أولئك الذين لا تلهج حياتهم بغير اللغة العربية؟؟ لا ننسى أن الجغرافيا التي تغطيها الدولة السودانية علاوة على إتساعها أيضًا هي ذات طبيعة ريفية حتى فيما نظن بأنه مديني.
يظن هذا المقال أن بين تلك الجموع من يرغب جاهدًا في أن يتعامل مع الحياة كجملة من الحقائق متجذرة في التاريخ والثقافة وليست حزمة من الأمنيات تطلق في المجال العام و عبثًا يطول الإنتظار بأنها ستخلق وجدانًا مشتركًا لجماعة وطنية .
الشسوع المكاني به تجارب إنسانية متباينة تسعى بكل ما أوتيت من عقل وجهد للتواصل مع أهل السمع والأبصار والأفئدة بالمفهوم القرآني (( الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة)) لأن الوطنية لا تأتي مع زخات المطر بل يلزمها عملٌ دؤوب وشاق وأبسط حقوق تلك الجماعات وجود المترجم في المؤسسات. نعم مترجم هذا إذا قبلنا على مكرهةٍ أن اللغة العربية هي لغة الفضاء العام كأمر واقع تورطت فيه الدولة . علمًا أن أهمية اللغة الخاصة لا تقف عند حدود تقديم المعاملات الورقية عند نوافذ المؤسسات فالأمر يتعداها إلى خلق التفكير وتحديد (الأنا) والآخر . وهذا أمر ليس بغائب على علماء الدنيا والدين على حد سواء.
أمرُ بن عامر وحباب (( دون ألف و لام التعريف )) لعله نموذج يصلح أن نعيد من خلاله تقييم علاقة الدولة بالجماعات، وبالطبع ليس من نوايا هذا المقال الخوض في إثبات تاريخ الأرض واللغة فتلك مبذولة في بطون كتب التاريخ بكمية تذهل المرضعة، بل هذا المقال يرتضي بتواضع هذا الإنحسار للأرض واللغة في حدود الإقليم الشرقي فقط رغبةً في الإصلاح .
دعونا نفهم ما الذي يربط بن عامر وحباب وما هذا الإلتصاق الذي ليس حصرًا على السودان فحسب بل حتى في إريتريا وإن كان هناك الأمر أكثر إتساعًا ووضوحًا وخاليًا من كل المزايدات التي تملأ المشهد السوداني.
الرابط الذي يلاصق بين بن عامر وحباب هو اللغة (( تقرايت)) والجغرافية التاريخية . وبن عامر وحباب لغة إجرائية تقتضيها الضرورة الإجرائية في الكتابة للمجال العام في السودان، ولكن الحقيقة الإنسانية المسميين هما لإنسان تاريخي واحد الأصل في تسميته، هو كيان لغوي أي مجموعة لغوية تاريخية لها آثارها من أسوان إلى أكسوم، والظن التاريخي الشائع أنها لغة حمير ولكن هذا الظن قابل للتنقيب لإرتباطها بالآرامية القديمة وتشترك مع النوبيين في أساطير لذلك من المراجعات التاريخية المهمة التي يحتاجها هذا الفضاء الإكسومي بل من الدقة أن نقول الحبشي النوبي البجاويت والتقرايت يحتاج مراجعات لتحديد الإسم الحضاري وتفاصيله بمعنى هل النوبة تفصيل في حضارة حبشية أم الحبشية تفصيل في الفضاء النوبي، وتحديد من هُم الأحباش التاريخيين لأن الأمر ليس سهلًا كما يظن العقل الفاعل في المجال الوطني أن يأتي بالناس دون تاريخهم ولغاتهم ويطلب منهم أن يكونوا وطنيين من خلال تركيب تاريخي مقطوع النسب بالنسبة لهم .
لازلت أرى أن الإطالة وعدم الخوض في تفاصيل العنوان ضرورة لا تختلف عن ضرورة الشرح التفصيلي الذي يواجه كل سوداني في الفضاء العربي.
أليس كذلك الأمر في المهاجر العربية ؟ الكتابة عن السودان في الفضاء العربي ليست أمينة كما ينبغي، لأن الكاتب يعلم أن العقل العام هناك ليس مشغولًا بالتفاصيل لذلك قد يفاجئك أحدهم بأن فترة نميري كانت من أزهى عصور السودان، تخيل لو أردت أن تشرح له أن ذروة سنوات التدهور كانت هناك، وأن قطار الإنهيار الوطني كان في تلك الفترة في أقصى سرعة له . يحتاج منك الأمر إلى تفصيل .كذلك الأمر في مخاطبة الفضاء العام في السودان عن أن السودان به جماعات لغوية كحقيقة إنسانية ماثلة أمامنا فقط وعانت لإستيعاب الخطاب العربي الوطني وأن الأمر يبدو غريباً أن ننطلق من أن هناك حقائق وطنية جامعة . تلك إحدى المآخذ التي قد تفسر لنا جميعًا معنى الفشل السياسي العام أو ما بات محل إجماع أن السودان منذ الإستقلال أو منذ المقدمات التي سبقت الإستقلال فشل في إقامة المشروع الوطني لأنه وإن كتب في أدبياته أن السودان متنوع إلا أنه أخفق عن قصد في إدارة التنوع .
العلاقة بين الثورة الإريترية والمواطنة السودانية ((الأورطة الشرقية )) مربطها في اللغة لاغير فحينما أهمل السودان عن قصد اللغات الخاصة وفِي حال هذا المقال لغة التقرايت، كانت الثورة الإريترية تعتمد في خطابها كل الألسن وبالطبع لغة التقرايت بإعتبار وجودها هناك أيضا وبطبيعة المكان الجغرافي وانتشار الثورة في محيطها الداخلي والإقليمي وفِي هذه الحالة شرق السودان .و كان لابد من أن تسد الثورة الأريترية الفراغ الثقافي التاريخي الذي حاولت الدولة السودانية أن تهمله عن قصد وتقلل من مداه الجغرافي داخل السودان. من هنا لا أرى غرابة في أن تكون الثورة الإريترية جزءًا من تاريخ بن عامر وحباب بصرف النظر عن أماكن تواجدهم وماذا إن علمنا أنهم قدموا فيها من التضحيات الكثير بل يكفي القول أنها انطلقت من قراهم ومراعيهم .
أين كانت الدولة السودانية وما هو دورها في خلق الفكرة الوطنية ؟
الإجابة لمن يريد أن يعرف معلومة وعليه نتساءل متى نسأل الدولة عن إنتمائها للناس وليس بن عامر وحباب أو غيرهم من أهل اللغات الخاصة .
في مطلع سبتمبر ٢٠٢٠ بلغت ذكرى الثورة الإريترية العقد السادس وصناعها من أهل شرق السودان التاريخيين يضعون إمتحانًا للدولة السودانية وشعبها الخاص، هل ستنجح الدولة السودانية في إمتحان بن عامر وحباب شرق السودان؟
أختم بحادثتين كنت فيهما طرفًا، في محفلين يفترض أنهما من دوائر إنتاج الوعي والتبصير. الأولى كنت فيها ضمن أساسيين وكانت بمبادرة كريمة من الشاعر الصادق الرضي عرفانًا وإمتنانًا وتكريمًا ومؤازرةً للشاعر محمد الفيتوري عليه الرحمة إبان فترة مرضه الأخيرة والتي على إثرها فاضت روحه الى بارئها .
أزهقت روح تلك الإلتفاتة الكريمة بمداخلتين، واحدة لشخصية أكاديمية معروفة، والأخرى لأحد الحضور والقاسم المشترك بين المداخلتين هو نفي سودانية الفيتوري التي لم تكن من قضايا الأمسية حيث كان المدار شعريًا خالصًا.
الحادثة الثانية كانت ندوة أيضًا تناقش الهموم السياسية السودانية المزمنة ، والتي بطبيعة الحال كلما تعمق فيها المرء يكتشف فداحة الخلل الهيكلي الذي شيد كحاملٍ للمشروع الوطني، وفيها انبرى أحد الحضور وقال أنه ترك مباراة مهمة وأتى هنا ليستفيد لا ليسمع لكلام ناس منصور خالد ولعله يقصد إجتهادات الراحل المتميزة في المساهمة لإصلاح الوعي العام وإهدائه سبل الرشاد للإصلاح السياسي .
أبطال الحادثتين لا تثريب عليهم لأنهم من الذين تلهج الدولة السودانية بلسانهم وهم أيضا إخوة الذين يسألون من أين أتى هؤلاء الناس.
شغلونا عن ذكرى رحيلك
أو قل عن متى ولدت وكيف كان العالم يوم ميلادك
في الأعوام التي تلت الحرب الأولى
أو قل بين الحربين
كانت بذرة الشعر تتشكل
وَيَا للمفارقة كانت الحية الرقطاء
أيضاً تدس السم في النفوس
عذرًا كجراي
أقصد بالحربين
حروب الكون الأولى والثانية
كتب في الأزل أن تولد
قالوا لنا أن شعرك الإريتري فاسدٌ
أغنياتك ليست عذراء
عذرًا أيها النهر
كنت تعيش في المجرى
في درب التاريخ
ومن أثر القافلة
تجمع خطوط الأرض
والوشم على جبين الحياة
وعليك
تذهب إلى نبع المياه
تلتقيها عند المنحدر
تقص عليك
وترنو من صدرها
عذرًا كجراي
