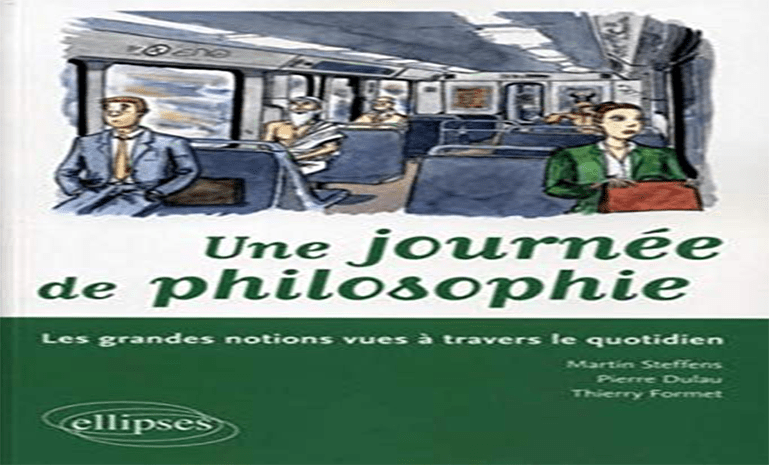
افتتاح الشّاشة
المصطلحات: نّوافذ «windows»، سّافاري «Safari»، الإكسبلورَر «Explorer»، الڤيستا «Vista»، والأوتلوكّ «Outlook» (العرض والمنظوريّة) إلخّ، كلّها عبارات نصادفها بشكل اعتيادي جدّا، بينما نحن نستعمل جهاز حاسوبنا (الكمبيوتر) الخاصّ، وهو المُشَبَّع بها، هي غيرها من العبارات الأخرى، كالــ«open». بلا شك، هذه العبارات ترمز إلى الذكاء (انفتاح النّظر والفهم) والحرّيّة (انفتاح الأفق بدون حدود) التي يتمتّع بها الإنسان الحالي. فلذلك، يعدنا جهاز الكمبيوتر عبر مصطلحاته الّتي تمّ إطلاقها على مختلف تطبيقاته باستكشاف آفاقٍ رحبة والسّفر عبر التّقنية إلى آفاق مُغامِرة.
إنّه عند عودتنا إلى المنزل بعد يوم عمل، عادة ما نجلس في مكتبنا ثمّ نشرع في رحلة سفر غريبة عبر هذه التّقنية الجديدة. إنّها رحلة شيّقة تلك الّتي تأخذنا عبر النوافذ الجميلة للحاسوب إلى عالمٍ حيث الصّور والأصوات والنّصوص والأشياء والأشخاص، فيتركّز كلّ ذلك الاختلاط في سطح واحد. إنّه سطح الشّاشة. شاشة الحاسوب الّذي يجعل أيّ شيء مقنعًا، يجعله معتمًا (مثلما نتحدّث عن واقٍ شمسيّ، فهو “شاشة كاملة”). شاشة حاسوبنا، عندما تزعم فتحَ عين ذكائنا وحاجة هروبنا، ماذا تُخفي عنَّا حقًّا؟ يمكن الاستمتاع ببيئتنا الحسّيّة الفوريّة، بحيث يكون بالإمكان، في حالة عدم النّظر إلى نافذة شقتنا، الاستمتاع بها [عوضا عن ذلك] عبر ما يَعِد به برنامج “نوافذ”Windowsوبرنامج الـExplorer. وأمّا في حالة عدم سماع أصوات الشّارع بالخارج، فلسوف نسمعها بواسطة أصوات الحاسوب. الواقع إذَا أنّه من الممكن التّغيُّب عن العالم الحقيقي، ومع ذلك مشاهدته عبر العالم الافتراضي لهذا الجهاز.
كيف تتأتّى إذَا هذه النّوافذ السّوداء؟ وماذا تريد أن تُظهِر؟ ثمّ ما هي الشّروط الّتي تسمح لها بعرض ما لديها؟ كما يعتقد ذلك مصمموها، ليس ما تعرضه هذه النّوافذ أقلّ من الواقع الّذي تنفتح عليه في كلّ الكون المنظور. لكن، وكما أشرنا لتوّنا، فإنّ هذه الفكرة مضلِّلة، لأنّها، على وجه التّحديد، تشترط التّخلّي عن الكون الحسّيّ الحقيقيّ الفوريّ بمجرّد الولوج إلى عالمها الافتراضيّ الوسيط ذاك. فقد يمكننا رؤية شيء ما بوضوح عبر هذه الشّاشة، وبفضلها فقط؛ لكنّها ستبقى رؤية من الدّرجة الثّانية فقط. إنّ هذه النوافذ، ذات الأطراف الصّناعية، هي أوّل النّوافذ الّتي ألحقت بعقولنا النافذة الأصيلة. لذا، فنحن ننظر إلى الصفحات الّتي لا نديرها عبرها، ونجعلها تظهر وتختفي حسب رغبتنا؛ إنّها فقط صفحات مختزلة في طبيعتها الأساسيّة، وهي بذلك مجرّد سلسلة من الرّموز. هكذا، فالعالم الّذي يَعِد به هذا الفتح الكبير هو مجرّد رمز عظيم؛ إنّه آلة مخصّصة لنا للحفظ والتّشفير السّريع. الصّور الّتي نراها هي تفسير محسوب للواقع: إنّها نسخة مشفَّرة منه. أليست الطّبيعة، بحسب مقولة غاليليو، كتاب عظيم مكتوب بلغة رياضيّة؟ هذا الأمر مؤكّد، لكن ليست الطّبيعة فقط، بل الثّقافة أيضًا؛ بالتّالي، كلّ ما هو موجود في عصر التّقنيّة الكوكبيّة. تقرأ الآلات لغة العالم هذه، ثم تعرضها على أنظارنا كي يصبح لها معنى مدلول. لقد أصبح بالإمكان في جهاز الحاسوب، وهو أمر نادر الحدوث، أن يخبرنا الحساب بشيء ما. وهذا الحساب له ثمن الآن، فهو السّبب في كوننا ندفع لنرى من خلال هذه الشّاشات السّوداء.
القفز من النّافذة
ما يقع على شاشة الحاسوب هو انعكاسات رياضيّة للعالم الّذي نعيش فيه؛ إنّها تأمّلات مركَّبة، يتمّ عبرها إعادة صياغة هذا العالم وفقًا للضّرورات الّتي نسمّيها بتعبير قويّ “التّكنولوجيا المُتقدِّمة”. “ثقافتنا العالية” لم تعد كما كانت عليه سابقًا: فقد كانت مقاييسها الكتب. لكن الآن حلّت محلّها “التّكنولوجيا المُتقدِّمة” الّتي تُعَدّ الشّاشة معيارًا لها. تستدعي هذه التّقنيّة العالية كلّ ما يمكن للعالم أن يقدّمه لإخضاعه لمتطلبات السرعة، ولإمكانيّة الوصول واللّحظة الّتي أصبحت من متطلبات الرّوح المعاصرة، والّتي تلبّي الرّغبة في القدرة المطلقة. عند تشغيله، يعدنا جهاز الحاسوب بمعرفة العالم الّذي يحتاج للاكتشاف في لمحة البصر. في هذه الحالة، يكون برنامج “فيستا” المعلوماتيّ خيارًا لدينا، مثله مثل الملاكم الّذي يدرك فجأة أنّ هناك “فجوة” للاستغلال، أو مثل تلك الفتحة الّتي يقوم بها عالم الفلك لمعرفة، عبر السماء المرصعة بالنجوم، كيفيّة عزل كوكب غير “نافذة”. هناك من سوف يعتني بشيء ما عبر تمهيد الطّريق نحو هذا العالم [كما هو متاح عبر نوافذ الفيستا] شريطة ألّا يكون هذا الأخير، بعد الآن، مسرحًا رائعًا للصّور الجاهزة. اللّعبة هذه تستحقّ شمعة على ما يبدو؛ ثم نقفز من النافذة، وبأعجوبة ها نحن لا نقع في الفراغ، لكننا نطير بعيدًا وبشكل مجّانيّ. هذا كلّ شيء، ها نحن على اتّصال.
روح العالم
لقد اعتقد القدماء بأنّ العالم كان كائنًا حيًّا، جسمًا حيًّا كبيرًا له “روح”. من خلال هذه الكلمة، حدّدوا شيئين اثنين: من ناحية، فهو مبدأ اتّصال بين كلّ الأشياء الّتي تُشكّل العالم، وهو ما يعرّفهم ويربطهم بالسّلطة ذاتها؛ ومن ناحية أخرى، يُعَدّ مبدأ الحركة الّذي يسمح بتطوّر كلّ الأشياء، بالتّالي هو عامل ديناميكيّ يسمح بالتّحوّل. على ضوء هذا التّعريف للنّفس، ليس عبثًا التّأكيد على أنّ شبكة الإنترنت الحاليّة، للأفضل أو للأسوأ، هي روح هذا العالم المعاصر الّذي غدا خارقًا، يتكوّن من قطع فنّيّة تقنيّة تميل جميعها نحو التّوحيد. لقد أصبح الكائن الحيّ آلة كبيرة جدًّا. هكذا أصبحت الأشياء فيه صورًا لأشياء أخرى، ولم تَعُد الصّلة بين هذه الأشياء رابطًا متناسقًا أو متعاطفًا، وإنّما علاقات رقميّة– Algorithmes[خوارِزميّات]. لقد أصبحت ديناميكيّة الهاتف المحمول برنامج خدمة. ولكن الحقيقة بقيت كما هي: يقوم الإنترنت بتحديد وربط كلّ عنصر من عناصر الكون المعاصر في فقّاعة من البيانات، ممّا يجعله يبدو أنّه متنقّل ومتجسّد إذا جاز هذا التّعبير.
إعلان
وإذا قمنا بتعميق هذه النّقطة، فسوف نقول، بدايةً، إنّ هذا الإنترنت هو بالفعل عامل موحِّد، لأنّه وساطة مطلقة. ليس للإنترنت غرض آخر عدا محتواه الخاصّ، فهو نظام الإحالات الّتي ما فتئ يشكّلها. إنّ شَبكَته آلة ربط؛ وهذا هو السّبب في كونه يبدو كأنّه يهزم تصوّرنا للفضاء وللزّمن. فبقدر ما نعلم أن مكاتب وخوادم “Google” موجودة في “كاليفورنيا”، تظلّ الحقيقة أنّه عندما “نتصفّح” الـ«ويبّ»، فإنّنا نلج أيّ فضاء بمعنى المكان. نحن نتصفّح سلاسل فهرسة البيانات متلألئة وجذّابة، مذهلة، أو مفيدة ببساطة، فنصل من خلالها إلى المحتوى المعلوماتيّ. لكن، الإنترنت نفسه، كظاهرة كونيّة، ليس في أيّ مكان؛ أو بتعبير أدقّ، إنّه في كلّ مكان -(كم عدد الإعلانات الّتي توضح لنا حقيقة أنّه في وسط الصّحراء يمكننا الاتصال؟)- وليس في أيّ مكان، فلا هو في الصّحراء ولا في المدينة ولا في الرّيف. تمامًا، مثل “روح” القدماء، تلك الرّوح الّتي في الجسد الحيّ، والّتي، من جذور الشّعر إلى أظافر القدمين، تبدو كما لو أنّها تتخلّل كياننا بالكامل دون أن نكون قادرين على القول -سرًّا- أين يوجد هذا المبدأ الّذي نشعر عبره بشعرنا وأظفارنا. كان هذا المبدأ، الّذي يوحّد الاختلافات الحقيقيّة، يتخذ لدى الحكماء -القدامى- طبيعة روحيّة. غير أنّنا الآن نناقضهم بعبقريّتنا التقنيّة: فهو ليس روحانيًّا، إنّه فقط جهاز حاسوبيّ آليّ. إنّ التّفكير هو الحساب، وبهذا الأخير يتمّ توصيل البيانات. الإنترنت في الواقع يربط، لكن عن طريق الوساطة التقنيّة للواقعيّة؛ حيث يتم ربط كلّ الأشياء على الأرض: السّلع الاستهلاكيّة والأفراد والمشاريع والأحلام والشّكوك، إلخّ. كلّ هذا يندمج، بعد ذلك، في التّألّق المذهل لصورةٍ ما على شاشة الحاسوب، أو الهاتف الخلويّ، ليتراءى في مرآة شبكيّة العين لدينا الّتي تطبع وعي تفكيرنا بختمها.
بالإضافة إلى كونها وساطة مطلقة، فإنّ الإنترنت، مثل الرّوح، هو مبدأ للحركة. وهذا يعني أنّ مبدأ الفصل إلى أَجلٍ غير مُسمّى، هو ما يحشد ويساهم في تحويل النّظام التقنيّ. إنّ الكون الّذي تحوّل إلى مُجرّد عالمٍ من صور، يجد في النّصّ المتشعّب لهيبه وديناميّته؛ وهذا ما يعني، بشكل ملموس، أنّنا معتادون على فهرسة معنى وجودنا على مختلف التّحوّلات والابتكارات الّتي تؤثّر على الإنترنت عبر الويبّ. فمتى ترك شخص ما رسالته على صفحة العرض الخاصّة بنا، عندها يكون من الضّروريّ علينا الإجابة عليه. هكذا، يتمّ تضمين هويّتنا في ملف يلتقي فيه جميع الطّلّاب السّابقين في مدرسة «شارلروا الثّانويّة»، إلخّ؛ فالنّبض والإيقاع ووتيرة الأخبار (كبيرة أو صغيرة)، كلّها تعود في الواقع إلى نوع من مكابدة الفضاء الرّقميّ، ولزمنه، الّذي يدّعي أنّه حقيقيّ.
متى؟ وأين هو الإنترنت؟
لعلّ هذا هو المكان الّذي نجد فيه يومنا الفلسفيّ. في أيّ وقت نتحدّث عن الإنترنت من اليوم، يُطرح السّؤال: ما الّذي يستدعي، والحالة هذه، الجلوس أمام مرآته؟ في أيّة لحظة من اليوم يوجد ما يتحدّى النّهار واللّيل، كما يفرض ذلك الزّمن الفعليّ، دون توقّف ولا راحة ولا تقلّص؟ في أيّ وقت من اليوم يمكننا تشغيل جهاز حاسوبنا الخاصّ ما دام يمكن تشغيله، في الواقع، في أيّ وقت ولأيّ سبب؟ متى تلزم الإشارة إلى ما يبدو بطبيعته متناقضًا مع وجود هذا الفضاء؟ باختصار، الإنترنت لأنّه يتحدّى الفروق الجسديّة والمكانيّة والزّمنيّة الّتي تبني وجود أبناءنا، فإنّه يُلْزِمنا التّفكير في حدود استعماله. وما هو المعنى المحتمل الّذي يمكن عبره تحليل كيفية استخدام الـ«إنتل» للإنترنت، والواقع يشي بأنّ هناك عدّة مليارات من الأشخاص (سواء كانوا لديهم حقّ الوصول إليه أم لا) الّذين يرون حياتهم محدّدة بواسطة هذه البنية الرّقميّة المطلقة؟ من خلال إعادة كلّ شيء إلى ذاته، وربط جميع الأشياء ببعضها البعض، يبدو أنّ الإنترنت هو روح هذا العالم: عالم الآلات والأطراف الاصطناعيّة الّتي توجّه انتباه النّاس إلى معرفة ما يريدونه من منتجاتها.
المرآة
لأنّه منتشر في كلّ مكان، يعتبر الإنترنت النّقطة المحوريّة لهذا اليومي؛ ولأنّه كذلك، فلا مكان له محدّد أيضًا، حيث إنّه يلغي معناه بشكل مستمرّ ودائم. وينكر في الواقع دورة النّهار واللّيل، كما يناقض العمل والتّرفيه بين المشاهد والممثِّل، وفيما بين المعلومات والخيال، الرّاحة والنّشاط. يمكن للمرء أن يرى هنالك فقط احتمالًا مزعجًا لـsupernature» » التّقنيّة الّتي تنفصل تدريجيًّا عن تربتها الطّبيعيّة، والّتي، لهذا السّبب، تولّد مشاكل أخلاقيّة لا نهاية لها: اضطراب القيت على مفهوم المِلكيّة، على مفهوم التّواضع، على فكرة الحقيقة، إلخّ. يمكننا أيضًا أن نرى فيه، كما أشرنا للتوّ، الضّرورة المُلحَّة الّتي تضعه إبداعات الإنسان: كضرورة أن تفترض مسبقًا تحديدًا تاريخيًّا جذريًّا. فبعد كلّ شيء، وإذا ما أصبح العالم كائنًا حيًّا كبيرًا (ما كان يخشى رجال القرن العشرين أن يتوقف مع ذلك عن كونه) مرة أخرى، فسوف يوجب علينا الكائن الحيّ السيبرانيّ الكبير، بالتّأكيد، معرفة ما تعنيه ظاهرة الحياة، والمعنى الّذي ينبغي أن يرشدها، والغرض الّذي ينبغي أن تعفيه من تناقضاتها، وذلك أكثر من أيّ وقت مضى. فالوعد بالحرّيّة الّذي تتضمّنه كلّ هذه الأسماء: النّوافذ، الفتح، المنظورات، رحلات الإبحار؛ كلّ ذلك يجد صدًّا فريدًا في وجود الآلات. فاعتمادنا عليها وارتباطنا العاطفي، أحيانًا، بحضورها، لهو دعوة لمعرفة معنى الإنسان.
إنّ هذه المصطلحات التقنيّة الجديدة، وبعد أن نجحت في خلق هذا العالم الحيّ من خلال أعمالنا ورموزنا وأرقامنا، يلزمنا الآن أن نتعلّم كيف نتعرف عليها. فهي ليست ما نريد أن نفعله، ولكن لأنّ العالم، بما فيه الافتراضيّ، ليس أداة نتعامل معها، وإنما ما نريد أن يصبح عليه: فهو إكسير يتعيّن علينا شربه مهما كلّف الأمر. إنّ الشّاشة فتحة في الواقع، نفتح من خلالها نافذة، وهذه النافذة هي المرآة.
[1] Pierre Dulau, et autres, Une journée de philosophie, éditions ellipses, Paris, 2010, pp 92 – 97.
