قراءة لقراءات: كتابُ الخِفة
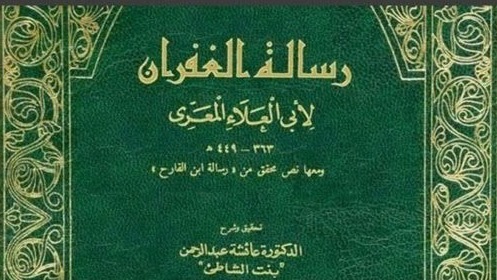
قراءة لقراءات: كتابُ الخِفة
الخِفة مفهوم أربك به ميلان كونديرا الأدباء، أو على وجه الدِقة: المراوحة بين الخفة والثقل، فدون بعضهما لا يكونان. ولعل مزية كونديرا ومأثرته تكمن في هذا التجريد والنمذجة للأسلوب التي اتبعها في سائر أعماله رفقة أسلوب آخر هو صنو الأول: مزج الواقع المتخيل بالخيال المحض، والانتقال الساحر بينهما، متبِعا في ذلك درب كافكا وسيرفانتس. ولتفضيل الخفة عنده أسباب بينها في مواضعها، سواء في أعماله الروائية أو تأملاته النقدية.
قديما، سمتِ العرب الانتقال من موضوع إلى آخر في القصيدة بحسن التخلص، وفي الغالب يكون الموضوع الأول نسيبا وتذكرا للمحبوبة يثقل قلب وذاكرة الشاعر، فيتسلى عنه بصرفٍ عُقارٍ، بالكأسِ يديرها الأصحاب كاشفةً للبلوى كما عند أبي نواس، أو قد يستعين الشاعر على الهمِ بالرحلة والحركة، إذ كل ابن همٍ بليةٌ عمياء في قول الحارث بن حلزة -والبلية هي ناقة الميت تعكس على قبره مقيدة ليجدها عند مبعثه، وهي عمياء لا تنطلق لغرضها، فكل صاحب همٍ مثقلٌ به حاله كحال تلك الناقة-.
ولعل أشهر انتقال في سياق الشعر العربي هو عند البحتري، حين انتقل من شكوى الدهر وتطفيفه لحظه اليسير من العيش، إلى وصف إيوان كسرى، فهو وإن مضى إلى إيوان المدائن ليعزي نفسه بأن حضارة عظيمة كتلك قد زالت بفعل الزمن الذي أساء إليه وكدر عيشه، إلا أنه منطلقا من بقايا القصر يشيد ويصف آخرا من الكلمات ويتذكر حال ملوكه في غابر الأزمنة ويتخيل منادمته إياهم، والإيوان وإن كان أقدم من القصيدة ومستمرا في الحضور حتى اللحظة فإن خلوده قليل إن قويس بخلود القصيدة ولنتذكر مقولة لبورخيس: “الزمن الذي ينهب القصور، يثري الأشعار”، قال البحتري:
حَضَرَت رَحلِيَ الهُمومُ فَوَجَّهـتُ *** إِلى أَبيَضِ المَدائِنِ عَنسي
أَتَسَلّى عَنِ الحُظوظِ وَآسى *** لِمَحَلٍّ مِن آلِ ساسانَ دَرسِ
أَذكَرتِنيهُمُ الخُطوبُ التَوالي *** وَلَقَد تُذكِرُ الخُطوبُ وَتُنسي
هاهنا مقاطع من أعمال سردية -ليس من بينها مقاطع لكونديرا، وإن كان الأول منها مقطع فتنه كثيرا ويفتن كل من قرأه- وهو مشهد ذهاب يوزف ك للجلسة الأولى من محاكمته في رواية (المحاكمة) لكافكا-، وقد أفرد له مقالا في كتابه (الوصايا المغدورة) يقارن فيه بين سوداوية أورويل المُطْبِقة في روايته (1984) الأقرب إلى الدعاوى السياسية والأيديولوجيا منها إلى الأدب وبين خيال كافكا القادر في خضم الرعب على ابتداع نوافذ مشرعة نحو الجمال وإن كان عاديا ومألوفا. المهم ليس هذا موضع فحص هذه المقارنة.
كل مقطع من الخِفة يسبقه ثِقلٌ ما متعلق بالحالة النفسية والشعورية للشخصية الخيالية أو بالموضع الذي توجد فيه، وبالنسبة للقارئ فإن هذا التحول المفاجئ في مخيلته بين مشاهد الخفة والثقل هو الساحر والمدهش، ولذا سأحاول تلخيص مشاهد الثقل لكي يتجلى هذا السحر:
-اليوم الأول للمحاكمة:
في رواية (المحاكمة) يستيقظ يوزف ك ليجد نفسه متهما بذنبٍ غير محدد، ومحاصرا برجال القانون في درجاتهم الدنيا غير العارفين بطبيعة ذنبه، في الفصل الأول يكمن الثقل في الوضع المفاجئ والغريب الذي وجد يوزف ك نفسه داخله، في حيرته من تصرفات رجال القانون المجترئة على حيزه الخاص دون مبرر منطقي، وفي عدم استعداده لكل هذا، وفي الجدال الطويل الذي خاضه في نفسه بين الانصياع للوضع الجديد أو مقاومته ورفضه باعتباره عبثا، لكنه في النهاية يخضع ويقرر الذهاب للمحكمة ليعرف حقيقة تهمته، وفي الفصل الثاني تنطلق الخفة -وبعض منها كان في الفصل الأول، حين أعاد يوزف ك على مسامع الآنسة بورستنر ومرآها تفاصيل يومه العجيب-، بدءا من ركضه المضحك للحاق بموعد المحاكمة الذي لا يعرفه على وجه الدقة بعد أن رفض أن يستقل المركبات العامة، وحتى لحظة وصوله لمحيط المحكمة، حيث يتكشف عالم أخاذ من الجمال العادي واليومي -يمكن مراجعة مقال كونديرا عن هذا المشهد- ليسترد ك أنفاسه ويجيل بصره في هذا العالم- وإن كانت رداءة الترجمة المقتبسة هاهنا تفسد شيئا من هذا الجمال-:
“كان ك قد فكر أنه سيتعرف على البيت من بعيد بعلامة ما لم يتصورها بوضوح أو بحركة خاصة أمام المدخل. ولكن شارع يوليوس الذي كان مفروضا أن يقوم فيه البيت، والذي وقف ك عند بدايته لحظة، كان يضم على جانبيه كليهما بيوتا توشك أن تكون متخذة على نمط واحد، بيوتا عالية رمادية يسكنها فقراء بالأجر. كانت معظم النوافذ في هذا الوقت، يوم الأحد صباحا غاصة بالناس، برجال لا يلبسون شيئا فوق القمصان ويدخنون أو يحملون بين أيديهم أطفالا صغارا بحذر وعطف عند حافة النوافذ. وكانت هناك نوافذ أخرى ممتلئة إلى أعلاها بفرش السرائر وكانت يظهر من فوقها رأس امرأة منكوشة الشعر. وكان الناس ينادي بعضهم البعض عبر الحارة، وقد أدى نداء من هذا النوع ب(ك) إلى ضحكة كبيرة. وكانت هناك في الشارع، محلات بقالة مختلفة موزعة بانتظام، منخفضة على مستوى الشارع، يصل الناس إليها بهبوط درجات سلم قليلة. كانت النساء تدخل وتخرج أو تقف فوق الدرج وتثرثر.
وجاء بائع فاكهة ينادي على بضاعته ويعرضها على من بالنوافذ، وأوشك، في شروده الذي يشبه شرود ك، أن يصدم ك بعربته ويقلبه. ثم بدأ جهاز جراموفون عتيق في عزف شيء بطريقة قاتلة.
وتوغل ك في الحارة ببطء، كما لو كان عنده متسع من الوقت، أو كما لو كان قاضي التحقيق يراه من نافذة من هذه النوافذ ويعلم أنه قد وصل. كانت الساعة تشير إلى بعد التاسعة بقليل. كان البيت بعيدا بعدا واضحا، وكان ممتدا امتدادا يوشك أن يكون خارجا عن المألوف، وكان المدخل خاصة عاليا واسعا، ويبدو أنه كان مخصصا لدخول الشحنات المنقولة بسيارات النقل والخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، التي تحيط بالفناء الكبير والتي كانت الآن مغلقة، وكانت هذه المحلات تحمل لافتات باسم الشركات التي تملكها، وكان ك يعرف عددا منها من عمله في البنك. ووقف عند مدخل الفناء قليلا على خلاف عادته في الاهتمام بكل هذه النواحي الخارجية اهتماما دقيقا. وكان هناك قريبا منه رجل حافي القدمين يجلس على صندوق يقرأ في جريدة. وكان هناك صبيان يتأرجحان على عربة يد. ووقفت أمام مضخة ماء بنت صغيرة السن ضعيفة البدن في قميص النوم وكانت تنظر إلى ك بينما انساب الماء من المضخة في الوعاء الذي أتت به. وكان في ركن من أركان الفناء حبل مد بين سباكين، علقت عليه الملابس المغسولة لتجف. ووقف رجل في الفناء يدبر العمل من أسفل بصيحات يطلقها.”
-مجتزأ من الفصل الثاني: التحقيق الأول
-رواية (المحاكمة)، فرانتز كافكا، تر: مصطفى ماهر
-يوم الحشر:
الخِفة هي جوهر عمل المعري العظيم (رسالة الغفران)، فأي خفة أكثر من تخيل شاعر لِلقاءٍ بأسلافه في العالم الأخروي بكل الجلال والرهبة المرتبطان بهذا العالم، ليحادثهم في مسائل نحوية وشعرية. يستغرب بعض من في الجنة من أسئلة ابن القارح وانشغاله بالأدب في مقامٍ كهذا، ويعلل شعراء نسيانهم لقصائدهم بأهوال القيامة، فيما يرد آخرون باقتضاب، يرد عليهم ابن القارح بأنه سأل الله أن يمتعه بأدبه في دنياه وآخرته. وهذا المقطع من حوار بينه وبين شاعر أنبأه بأنه نسي ما قدمه من أشعار، ليروي له ابن القارح حكاية وقوفه بيوم الحشر وكيف تخلص من أهواله عبر طلب الشفاعة أولا من الملائكة عبر قصائد في مدحهم، وحين لم يفلح طلبها من أعمام الرسول، وبعد أن يحصل على كتاب توبته، يرى هذا المشهد وفيه جماعة من الشعراء تحيط بعالم نحو أخطأ في رواية أبياتهم وغير معانيها، فيستغرق ابن القارح في الجدال رغم ما هو فيه من طلب النجاة لنفسه:
“وكنت قد رأيت في المحشر شيخا لنا كان يدرس النحو في الدار العاجلة، يعرف بأبي علي الفارسي، وقد امترس به قوم يطالبونه، ويقولون: تأولت علينا وظلمتنا. فلما رآني أشار إلي بيده، فجئته، فإذا عنده طبقة، منهم يزيد بن الحكم الكلابي، وهو يقول: ويحك، أنشدت عني هذا البيت برفع الماء، يعني قوله:
فليت كفافاً كان شرُّكَ كُلُّهُ
وخيرُك عني ما ارتوى الماءُ مرتوِي
ولم أقل إلا الماءَ. وكذلك زعمتَ أني فتحتُ الميمَ في قولي:
تَبَدّل خَليلاً بي، كشكلِك شكلُه
فإني خليلاً صالحاً بكَ مَقْتَوي
وإنما قلتُ: مُقتَوي بضم الميم.
وإذا هناك راجزٌ يقول: تقولت عليّ أني قلتُ:
يا إبلي ما ذنبُه فتأبيِهْ؟ ماءٌ رَواءٌ ونَصِيٌّ حَوْلِيَهْ
فحركتَ الياءَ في تأبِيَه، وواللهِ ما فعلتُ ولا غيري من العرب.
وإذا رجلٌ آخر يقول: ادّعيتَ عليّ أن الهاء راجعةٌ على الدَّرْسِ في قولي:
هذا سُراقةُ للقرآنِ يَدْرُسُهُ
والمرءُ عندَ الرَّشا إن يَلقَها ذيبُ
أفمجنون أنا حتى أعتقد ذلك؟
وإذا جماعة من هذا الجنس كلُّهم يلومونه على تأويله. فقلتُ: يا قومُ، إن هذه أمورٌ هيّنةٌ، فلا تُعنِتوا هذا الشيخَ، فإنّه يَمُتّ بكتابه في القرآن المعروف بكتاب الحُجّة، وإنّه ما سفَكَ لكم دماً، ولا احتجَن عنكم مالاً، فتفرقوا عنه.
وشُغِلتُ بِخطابهم والنّظرِ في حَويرهم (أي محاورتهم)، فسقط منّي الكتابُ الذي فيه ذِكرُ التوبة؛ فرجعتُ أطلُبُه فما وجدتُهُ. فأظهرتُ الولَهَ والجزَع.”
-مجتزأ من الفصل الثاني: موقف الحشر
– (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري، تحقيق: عائشة بنت الشاطئ
-عرس في الصحراء:
هذا مقطع نموذجي في الخفة من رواية الطيب صالح (موسم الهجرة إلى الشمال)، نحن نعرف تملك قصة مصطفى سعيد للراوي وسيطرتها على ذهنه وإن حاول التقليل من تلك الهيمنة أحيانا بمحاججات سرعان ما يبددها الحضور الطاغي لذكرى مصطفى سعيد ومحاولة الراوي لإيجاد تفسير لهذه القصة أو منجى منها – وهي رواية جمة عجائبها ولا تنقضي-، وفي هذا الفصل الذي يروي تفاصيل رحلة للراوي في الصحراء، حيث تتلاعب الشمس بأفكاره وتحت وطأة لهيبها يهذي ويهلوس متذكرا قصة سعيد، لكن بدءا من لحظة غروب الشمس تتوقف المحاكمة ويبرز عالم آخر، يكون فيه الراوي متفرجا على جماله ومباهجه التي تتوالى لتنسيه ما كان شاغلا له في الظهيرة، وتمحو ثقل الحكمة المتلقاة من سعيد، وينطق فيها الراوي بجمل وأحكام عن الحياة ما كانت لتوجد لولا أنه مأخوذ بسحر اللحظة الممتدة أمام ناظريه
وتحولاتها وزوالها في نهاية الأمر، إن الحالة النفسية تطابق منطوقه بدقة، يقول:
“شفق المغيب ليس دماً ولكنه حناء في قدم المرأة، والنسيم الذي يلاحقنا من وادي النيل يحمل عطرا لن ينضب من خيالي ما دمتُ حياً. وكما تحط قافلة رحالها حططنا رحلنا. بقي من الطريق أقله. طعمنا وشربنا. صلى أناس صلاة العشاء، والسواق ومساعدوه أخرجوا من أضابير السيارة قناني الخمر، وأنا استلقيتُ على الرمل وأشعلت سيجارة وتهت في روعة السماء. والسيارة أيضا سقيت الماء والبنزين والزيت، وهي الآن ساكنة راضية كمهرة في مراحها. انتهت الحرب بالنصر لنا جميعا، الحجارة والأشجار والحيوانات والحديد. وأنا الآن تحت هذه السماء الجميلة الرحيمة أحس بأننا جميعا أخوة. الذي يسكر والذي يصلي والذي يسرق والذي يزني والذي يقاتل والذي يقتل. الينبوع نفسه. ولا أحد يعلم ماذا يدور في خلد الإله. لعله لا يبالي. لعله ليس غاضبا. في ليلة مثل هذه تحس أنك تستطيع أن ترقى السماء على سلم من الحبال. هذه أرض الشعر والممكن وابنتي اسمها آمال. سنهدم وسنبني وسنخضع الشمس ذاتها لإرادتنا وسنهزم الفقر بأي وسيلة. السواق الذي كان صامتا طوال اليوم ها قد ارتفعت عقيرته بالغناء. صوت عذب سلسبيل لا تحسب أنه صوته. يغني لسيارته كما كان الشعراء في الزمن القديم يغنون لجمالهم:
دركسونك مخرطة وقايم على بولاد
وغير ست النفور الليلة مافي رقاد
وارتفع صوت آخر يجاوبه:
السفر من دار كول والكمبو
هوزز راسه فرحان بالسفر يقنبه
أب دومات غرفن عرقه يتنادن به
ضرب الفجة واصبح ناره تاكل الجنبه
ثم نبع صوت ثالث يجاوب الصوتين:
واوحيحي ووا وجع قلبي
من صيدة القنص الفترت كلبي
القاري العلم من دينه بتسلبي
والماشي الحجاز من جده بتقلبي
نحن هكذا وكل سيارة تمر بنا طالعة أو نازلة، تقف، حتى اجتمعت قافلة عظيمة، أكثر من مائة رجل طعموا وشربوا وصلوا وسكروا. ثم تحلقنا حلقة كبيرة، ودخل بعض الفتيان وسط الحلقة ورقصوا كما ترقص البنات. وصفقنا وضربنا الأرض بأرجلنا وحمحمنا بحلوقنا، وأقمنا في قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء أحد بمذياعه الترانزستور، وضعناه وسط الدائرة، وصفقنا ورقصنا على غنائه. وخطرت لأحد فكرة، فصف السواقون سياراتهم على هيئة دائرة وسلطوا أضواءها على حلقة الرقص، فاشتعلت شعلة من الضوء لا أحسب تلك البقعة رأت مثلها من قبل. وزغرد الرجال كما تزغرد النساء وانطلقت أبواق السيارات جميعا في آن واحد. وجذب الضوء والضجة البدو من شعوب الوديان وسفوح التلال المجاورة، رجال ونساء، قوم لا تراهم بالنهار كأنهم يذوبون تحت ضوء الشمس. اجتمع خلق عظيم ودخلت الحلقة نساء حقيقيات، لو رأيتهن نهارا لما أعرتهن نظرة، ولكنهن جميلات في هذا الزمان والمكان. وجاء أعرابي بخروف وكأه وذبحه وشوى لحمه على نار أوقدها. وأخرج أحد المسافرين من السيارة صندوقين من البيرة وزعهما وهو يهتف: “في صحة السودان. في صحة السودان”. ودارت صناديق السجائر وعلب الحلوى، وغنت الأعرابيات ورقصن، وردد الليل والصحراء أصداء عرس عظيم كأننا قبيل من الجن. عرس بلا معنى، مجرد عمل يائس نبع ارتجالا كالأعاصير الصغيرة التي تنبع في الصحراء ثم تموت. وعند الفجر تفرقنا. عاد الأعراب أدراجهم إلى شعاب الأودية. تصايح الناس: “مع السلامة. مع السلامة”. وركضوا كل إلى سيارته. أزت المحركات، وتحولت الأضواء من المكان الذي كان قبل لحظات مسرح أنس، فعاد إلى سابق عهده، جزءا من الصحراء. واتجهت أضواء السيارات، بعضها نحو الجنوب صوب النيل، وبعضها نحو الشمال صوب النيل. وثار الغبار واختفى ثم ثار واختفى. وأدركنا الشمس على قمم جبال كرري أعلى أم درمان”
-مجتزأ من الفصل السابع
-رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) ، الطيب صالح
-ميرسو على الشرفة:
مقاطع الخفة السابقة تشترك مع هذا المقطع في كون الشخصية الخيالية توجد في موضع المتفرج والرائي قبل أو بعد محاكمة طويلة للنفس، إنها تكتفي بالنظر والاستماع ولا تفعل شيئا، ولكن هذا المقطع أكثر إرباكا، فلتوصيفه بالخفة يتعين علينا أن نفسر الشخصية المعقدة لميرسو وموقفه من حدث كوفاة أمه، إن عناصر الخفة موجودة: فهو في البيت لوحده لأول مرة منذ وفاة أمه، يقضي إجازة يوم الأحد، ويتطلع إلى الشارع من شرفته، شارع يضج بمشاهد ألفها في آحاده الماضية، لكنها اليوم مسبوقة بحدث ثقيل، وهو وإن كان شعوره غامضا إزاءه وغير محدد- سيقول في المحكمة إن إعياء السفر والشمس كانت سببا في بروده المستغرب عند وصوله للقاء جثة والدته، أي حسب عباراته فإن جسده المتعب بدد أي شعور، وحواسه المرهقة طغت على العاطفة- هو كائن حسي بإفراط، حتى أن التذكر لم يتح له إلا داخل السجن، هناك استعاد بدقة وسواسية ذكريات حياته وبدأ في سرد قصته – لنتذكر شخصية خيالية أخرى، تضاعفت قوة ذاكرتها حال عجزها عن الحركة وسكونها في مكان واحد، وهي شخصية لبورخيس من قصته: ذاكرة فونيس الحية- البرود والرتابة التي يصف بها ميرسو عالم الشارع مصحوبة بالانتباه المفرط وأحكام وتأملات ضئيلة عن الفرجة لا تتيح لنا
الجزم بالحالة النفسية والشعورية له، لا مبالاته عجيبة لدرجة أننا نكتشف في نهاية الرواية أنه حكى كل هذا ليدعونا لتنفيذ إعدامه، كأنه يدعونا لحفل – علمنا ميرسو كيف نكون غرباء: صموتين، بردود مقتضبة، ومحولين انتباهنا بسرعة عن محدثينا، وغير معنيين بشيء سوى بسرد قصتنا لآخرين غائبين، لا بحثا عن سوء فهم آخر، ولكن دعوة لهم لحضور تنفيذ الإعدام الخاص بنا-
في هذا المقطع يلاحظ ميرسو حال المشاهدين حال خروجهم من السينما، ويقارن بين أولئك القادمين من المدينة والذين ذهبوا لسينما الحي، الأوائل استعادوا توازنهم من سحر الصورة، بينما هؤلاء ما زالوا مأخوذين بها ويحاولون محاكاتها- يقول:
“غرفتي تطل على الشارع الرئيس من ضاحية المدينة. كان الطقس، بعد الظهر، جميلا؛ ومع ذلك، فإن البلاط كان لزجا، وكان الناس نادرين، وفي عجلة من أمرهم. كانوا في بادئ الأمر أسراً تتنزه، وصبيين صغيرين يرتديان لباسا بحريا، نزل سروال كل منهما إلى تحت الركبتين، وكانا مرتبكين في ثيابهما الخشنة بعض الشيء. وكانت ثمة فتاة صغيرة عقدت شعرها بشريط خشن وردي اللون، وتنتعل حذاء لماعا. وخلفهم، كانت تسير أم ضخمة، ترتدي فستانا من الحرير كستنائي اللون. أما الأب، وهو رجل قصير نحيل بعض الشيء، فكنت أعرف شكله فقط. كان يرتدي لباس البحرية وربطة عنق، ويحمل بيده عصاه. وإذ رأيته مع زوجته، فهمت لماذا كانوا يقولون عنه في الحي إنه كان رجلا معتبرا. وبعد فترة مر شبان الضاحية، بشعورهم اللماعة وربطات أعناقهم الحمراء وستراتهم المحصورة جدا، والمناديل المطرزة والأحذية ذات المقدمة المربعة. وفكرت في أنهم كانوا ذاهبين إلى دور سينما المركز. من أجل ذلك كانوا يبكرون في الذهاب، وكانوا يسرعون نحو الترام مقهقهين.
بعد مرورهم، غدت الطريق مقفرة شيئا فشيئا. كانت عروض السينما والمسرح، كما أعتقد، قد بدأت في كل مكان. ولم يكن في الطرق بعد إلا أصحاب الحوانيت والهررة، وكانت السماء صافية ولكن دون ألق فوق الأشجار التي تزين الطريق. على الرصيف المقابل، أخرج بائع التبغ كرسيا ووضعه أمام بابه، ثم اعتلاه وهو يستند بذراعيه إلى ظهره. كانت عربات الترام الغاصة بالركاب، منذ فترة، فارغة الآن تقريبا. وفي القهوة الصغيرة، (شيبيارو)، بالقرب من بائع التبغ، كان الصبي يكنس النشارة في القاعة الخالية. ذلك هو يوم الأحد حقا.
… عند الساعة الخامسة، وصلت قافلة الترام في ضجيج، وكانت تعيد، من ملعب الضاحية، عناقيد من المشاهدين الذين تسلقوا السلالم والنوافذ. أما قافلة الترام التالية فقد أعادت اللاعبين الذين عرفتهم من حقائبهم الصغيرة. كانوا يزعقون وينشدون بملء حناجرهم أن ناديهم لن يهلك. ولقد أرسل إلي بعضهم إشارات، بل إن أحدهم صرخ لي قائلا: “لقد انتصرنا عليهم”. هززت رأسي، وأنا أقول: “نعم”. وابتداءً من تلك اللحظة أخذت السيارات تتوافد.
تقدم النهار قليلا، وأصبحت السماء حمراء، فوق السطوح. ومع المساء البازغ، أخذت الطرقات تعج. وراح المتنزهون يعودون شيئا فشيئا، فعرفت من بينهم السيد المعتبر. وكان الأطفال يبكون أو يستسلمون للجر. وفي الوقت نفسه تقريبا، أفرغت دور الحي السينمائية موجة من المشاهدين في الطريق، ومن بينهم شباب كانوا يقومون بحركات واثقة أكثر من العادة، وفكرت في أنهم قد شاهدوا فيلم مغامرات. وكان الذين يعودون من دور سينما المدينة يصلون متأخرين قليلا، ويبدون أكثر رزانة. كانوا ما يزالون يضحكون، ولكنهم كانوا يبدون، من وقتٍ لآخر، متعبين وحالمين. وقد ظلوا في الشارع، يذهبون ويجيئون على الرصيف المقابل. وكانت صبايا الحي يتماسكن بالأذرع، مرسلات الشعر. وكان الشباب قد أخذوا تدابيرهم لكي يلتقوا بهن، وكانوا يطلقون مزاحا تضحك له الفتيات وهن يدرن رؤوسهن. وقد بعث إلي بعضهن إشارات، وكنت أعرفهن.
إذ ذاك، أشعلت مصابيح الشارع فجأة، فجعلت النجوم الأولى التي كانت تصعد في الليل باهتة صفراء. أحسست بأن عيني تعبتا من النظر إلى الأرصفة من الرجال والأنوار. كانت المصابيح تلمع البلاط المبلل، وكانت قافلة الترام – لمسافات محددة- تعكس شعاعاتها على الشعور الملمعة، وعلى بسمة أو سوار من الفضة. بعد قليلا، خفت القافلات وهبط ليل أسود فوق الأشجار والمصابيح، فأخذ الحي يقفر رويدا رويدا، حتى الوقت الذي بدأ فيه أول قط يجتاز ببطء الشارع المقفر من جديد.
فكرت أنه كان يوم أحد انقضى، وأن أمي الآن مدفونة، وأنني سأستعيد عملي، وأنه لم يتغير شيء بالإجمال.”
-الفصل الثالث
-رواية (الغريب)، ألبير كامو، تر: يارا شعاع
