رحيل*
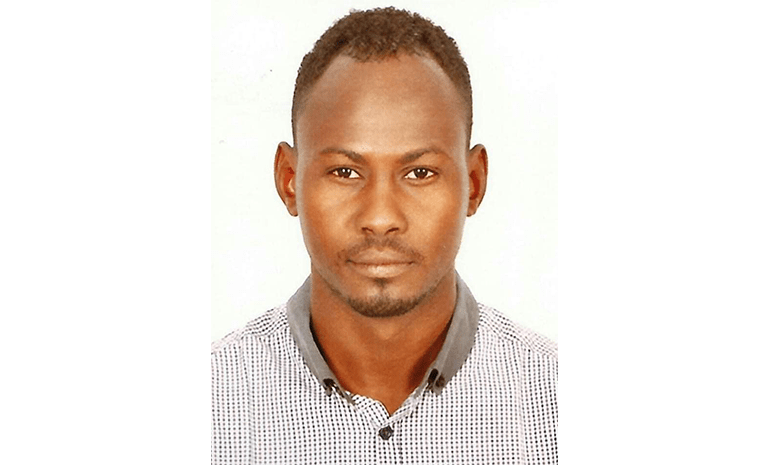
في ذلك اليوم، عدنا أنا وأبي من المزرعة، وفي وجهينا إيماضات شمس خاطفة، فقد بدأ الليل يبتلع الطبيعة، ويخنق كل حياة وكل حس.. أبي يحمل مانجو وليمون، وأنا أحمل سبعة أو ثمانية قناديل من الذُّرة والمصَر. كان الأطفال قد بدأوا الانسحاب رويداً رويداً من برك الطين، ومن أطراف القرية، وحتى صيادو الأرانب والطيور والسناجب، قد عادوا بكلابهم وبالصيد الوفير، يستقبلهم إخوتهم الصغار، وهم يطلقون صيحات الفرح، يهتفون بأصواتٍ عالية ويصرخون.. زعيم القرية يسير وحده ككلبٍ ضال، يضع حربة على كتفه، قبعة من السعف على رأسه، ويحيط خصره بفروة بيضاء، كثيرة الصوف، فيها الكثير من الودع والخرز، والسلاسل. استقبل أبي بوجهٍ خالٍ من النوايا، وقف الرجلان يتحدثان، فيما رحتُ أنا أتفرج على الغروب.. فكّرتُ وتأمّلتُ: الغروب ليس جميلاً كالشروق. نظرتُ إلى أبي، في وجهه لمعاتٍ من عمقِ السماء؛ نظرتُ إلى الزعيم، في وجهه تضاريس الزمن القديم.
لا أدري عمّ تحدث الرجلان، وبأي لغة؟ أبي لا يتقن غير عربية الشمال، والزعيم لا يتقن غير رطانته المحلية، لابد أنهما تفاهما بعربية الجنوب المكسرة!
افترقا في النهاية، رأيتهما يتصافحان كإنسانين ودودين، يبتسمان، ويهزان رأسيهما، الزعيم يرفع قبعة السعف التي تغطي صلعة منحدرة على منخفضات جمجمته، ثم يعيدها إلى مكانها كسِدادة. أبي يعيد الطاقية إلى منتصف الرأس، بعد أن أزاحها إلى الوراء، إكراما للزعيم.
وبما أني شغوفة بعض الشيء بالوصول إلى البيت، فقد تقدمت أبي بخطوات، حتى لم أنتبه ليد الزعيم المرفوعة في الهواء لأجلي، لكنه أطلق صفارته عندما رأى الأولاد العائدين من الصيد يتعاركون، فور أن خدشتْ بجرسها المفزع طبلات آذانهم، توقفوا عن العراك، وراحوا يرمون أبصارهم في كلٍ اتجاه، باحثين عن صفارة الزعيم، وعندما شاهدوه يخطو نحوهم كملك الموت، تراصوا، الأكبر فالأصغر، وهم يرتجفون، لأنهم يعرفون أن الزعيم لا يتسامح مع أشكال الفوضى. وقفت أتأمّلهم وهم يحيّون الزعيم بإجلال، ويخفضون رؤوسهم، حتى تجاوزني أبي. سمعت خشخشات نعاله، وهي تنزلق فوق بساط العشب الأخضر، أراهُ أمامي ولكنه منعدم الوجود فعلياً، كمثل رؤيا في الكَرَى، تأتي صورته مثل طيفٍ بطيء وتتلاشى.
ركضتُ في إثره. كانت هناك صياحات، ونداءات، في كل مكان. وجدنا ماما مانديلاد في انتظارنا. حمّمتْ أخي يعقوب، نظفت الكوخين، طبخت العشاء، وفرشت حصير السعف والبساط الأحمر القاني فوقه لأبي.
عندما رأت الخدوش في جبهتي ذعرت من الهلع، دقت صدرها وسألتني وهي تتحسس جبهتي ووجهي:
طفلتي مريام ما الذي حصل لك؟
ارتبكت قليلاً. لم أستطع النظر إلى عينيها.
سقطت في العشب عند ما كنت في الغابة. قلت لها.
آه يا طفلتي. لا تفعلي ذلك ثانية. زفرت.
أومأتُ.
رأيت أبي يتوضأ استعدادا لصلاة المغرب. أبي وأنا الوحيدان اللذان يصليان. المسلمان الوحيدان هنا. ماما مانديلاد تذهب إلى الكنيسة.
– أبي؟
– نعم
– هل سيصلي أخي يعقوب معنا، أم يذهب إلى الكنيسة مع ماما مانديلاد عند ما يكبر؟
سألتُ أبي ذات يوم عندما أكلني الفضول.
نظر إليَّ بعيون حنونة:
سيجد طريقه بنفسه.
أمرتني ماما مانديلاد بالتمدد على ظهري، جاءت بماء سخّنته تواً، غمست قطعة من القماش في الماء، عصرتها في التراب، حتى لم يبق من الماء إلا بعض الرُّذاذ، مسحتْ به الخدوش، شعرتُ بألمٍ واخِز، يسري خدره في رأسي. شعرتُ بالوجع وبِلهب غلْيان الماء، لكني لم أتأوّه.
انتهت من تضميد الخدوش، مسحت فيها بعض المراهم المصنوعة من لِحى الشجر. انبجست بخاطري رغبة في البكاء، غير أني تمالكت نفسي ولم أبك. اضطجعتُ على بطني ونمت.
أظنني تعشّيت في ساعة متأخرة من الليل. عندما استيقظتُ، كان أبي وماما مانديلاد وسط حديث جدّي لافِت. أثناء الفطور، أخبرني أبي أنه سيسافر إلى الشمال، وأن غيابه لن يطول. شعرتُ بغُصّة في الحلق، لم أتمكن من قول شيء. تحمّلتُ الصدمة على مضض. ساد صمت موجع في الكوخين. عند الضحى، وقفتُ أنا وماما مانديلا وأخي يعقوب في حضنها،وأسّان بليز وزوجته، والزعيم،وبعض الجيران، نُودّع أبي.
ركب عربة الكارلو. تتبعناه بعيوننا، حينئِذٍ وقبل أن أتفوّه بكلمة، انطلقتُ أجري صوب الكارلو التي ابتعدت، ركضتُ وركضتُ متقطّعة الأنفاس، حتى أحسستُ أن حنجرتي تيبّستْ من الظمأ. اندسسْتُ في الغابة ولم أعد أراها، رأيتُ فقط حوافر أقدام الحصان.
تلقتني ماما مانديلاد على مشارف الغابة، وهي تردد:
طفلتي مريام، سيعود أباك قريباً.
لكنني تملّصتُ من يدها، كنتُ غاضبة، صعدت إلى جذع شجرة المانجو الكبيرة، التي تحتضن كوخينا، وبدأتُ أبكي. توسّلتْ إليى ماما مانديلاد لأنزل من الشجرة، شاركتني بكائي، لكني لم أستجب لها.
قلتُ لجذع الشجرة: لقد رحل أبي، لقد رحل وتركني. ورحتُ أبكي. نزلتْ منه دمعتان ثخينتان، وراح يبادلني الشعور ويبكي بِجزع.
*من رواية “سيمفونية الجنوب“
